فيلم I’m Still Here… حين يُذكّرنا الفن أن الاستبداد إلى زوال مهما طال عمره

حين جلست لمشاهدة الفيلم البرازيلي (I’m Still Here) للمخرج والتر ساليس، لم أكن أمام عمل درامي عابر، بل أمام مرآة تعكس حاضرًا مألوفًا لنا نحن العرب، حتى وإن جرت أحداثه في ريو دي جانيرو إبّان حقبة النظام العسكري بين عامي 1965 و1985. يعيد الفيلم إلى الواجهة قصة النائب اليساري روبنز بايفا، الذي اختطفته أجهزة المخابرات عام 1971، ليختفي مصيره في دهاليز القمع، تاركًا وراءه زوجة صابرة وأطفالًا يتجرعون مرارة فقدان الأب. وما أشدّ قسوة أن يُحرم الصغار من والدهم، لا لذنب اقترفه، بل لأنه رفض الخضوع للظالمين وأبى أن يسود الاستبداد في بلاده.
أداء الممثلة البرازيلية فرناندا توريس في تجسيد شخصية الزوجة يونيس كان شديد الصدق، حتى بدا وكأنها تنقل نبض المعاناة من قلب الحقيقة لا من خشبة التمثيل. ومع ظهور والدتها، فرناندا مونتينيغرو، المرشحة سابقًا لجائزة الأوسكار، في مشاهد مؤثرة بدور يونيس في شيخوختها، اكتسب الفيلم بعدًا إنسانيًا أعمق، يربط بين الماضي والحاضر، ويُرسّخ صورة الصمود في الذاكرة الجمعية.
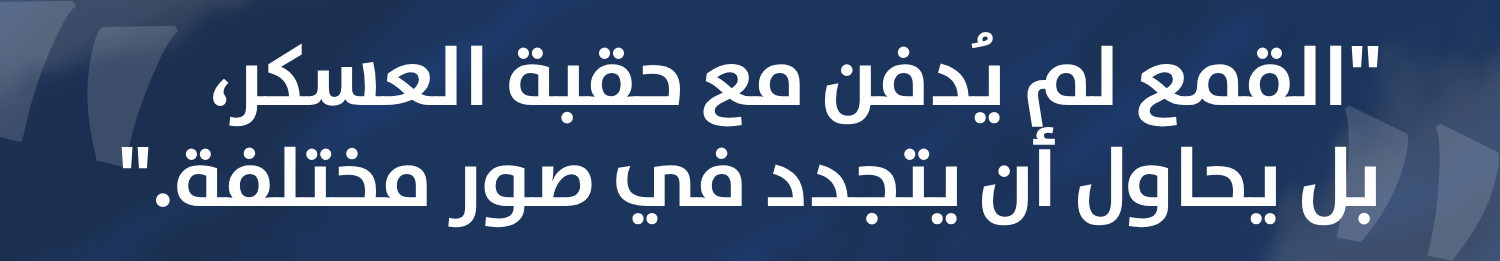
هذا العمل، الفائز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان البندقية السينمائي والذي جذب ملايين المشاهدين في دور العرض البرازيلية، لا يقتصر على إعادة بناء وقائع تاريخية مؤلمة؛ بل هو رسالة للحاضر، كما شدّد مخرجه، في زمن تتعالى فيه أصوات اليمين المتطرف وتتصاعد محاولات محو الذاكرة. فالقمع لم يُدفن مع حقبة العسكر، بل يحاول أن يتجدد في صور مختلفة، غير أن الفيلم يذكّرنا بأن أشكال المقاومة الصبورة قادرة على إفشاله مهما طال الزمن.
ورغم أن أحداثه تدور في بلد بعيد جغرافيًا عن منطقتنا العربية، إلا أن دلالاته تكاد تتطابق مع واقعنا. فكم من أبٍ صالحٍ ومحبٍ دفع حياته ثمنًا لموقفه الرافض للاستبداد؟ وكم من عائلة عربية عاشت مأساة مشابهة، حيث تحوّل غياب الأب من حادثة فردية إلى جزء من سردية أمة بأكملها؟ من هنا، فإن الفيلم لا يخاطب البرازيليين وحدهم، بل كل إنسان خبر معنى أن يُسلب الوطن حريته ويُقتل الحلم في مهده.
والرسالة الأعمق التي يحملها الفيلم هي أن الطغاة مهما تجبّروا فإن نهايتهم إلى زوال، وأن الشعوب التي تدفع ثمن حريتها صبرًا وتضحية هي التي تكتب التاريخ. فلو أفلت بعض المستبدين من حساب الدنيا، فلن يفلتوا من عدالة السماء، وإن بدت قوتهم راسخة، فهي إلى سقوط حتمي لا محالة.

بالنسبة لنا كأمة، فإن متابعة مثل هذه الأعمال ليست ترفًا ثقافيًا، بل فرصة للتأمل واستخلاص العبر. فنحن نعيش في مجتمعات تقدّر الفنون والسينما بوصفها جزءًا من الذاكرة الجمعية وأداة للتعبير عن القيم، ومن المهم أن ننقل هذه التجارب إلى أبنائنا كي نحفظ من خلالها ذاكرتنا نحن أيضًا. فالفيلم الذي يروي مأساة عائلة برازيلية يمكن أن يكون مرآة لقصص عائلات فلسطينية أو سورية أو مصرية وغيرها، عائلات قاومت القمع وبقيت متشبثة بالأمل. وبهذا تصبح السينما أداة تضامن عابرة للحدود، تذكّرنا أن الظلم إلى زوال مهما طال، وأن الإنسان، أينما كان، لا يُهزم ما دام يحمل في قلبه شعلة الحرية.
اقرأ أيضًا:
- فلسطين، البوصلة الّتي تحدّد موقفنا أمام أنفسنا، وكينونة الرّاحة في ضمائرنا..
- وثائق تكشف: كيف دعمت بريطانيا إسرائيل رغم معرفتها بجرائمها ضد الفلسطينيين؟
- اتهامات لـ«محامون من أجل إسرائيل» بابتزاز القطاع الصحي NHS
جميع المقالات المنشورة تعبّر عن رأي أصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المنصة
الرابط المختصر هنا ⬇










