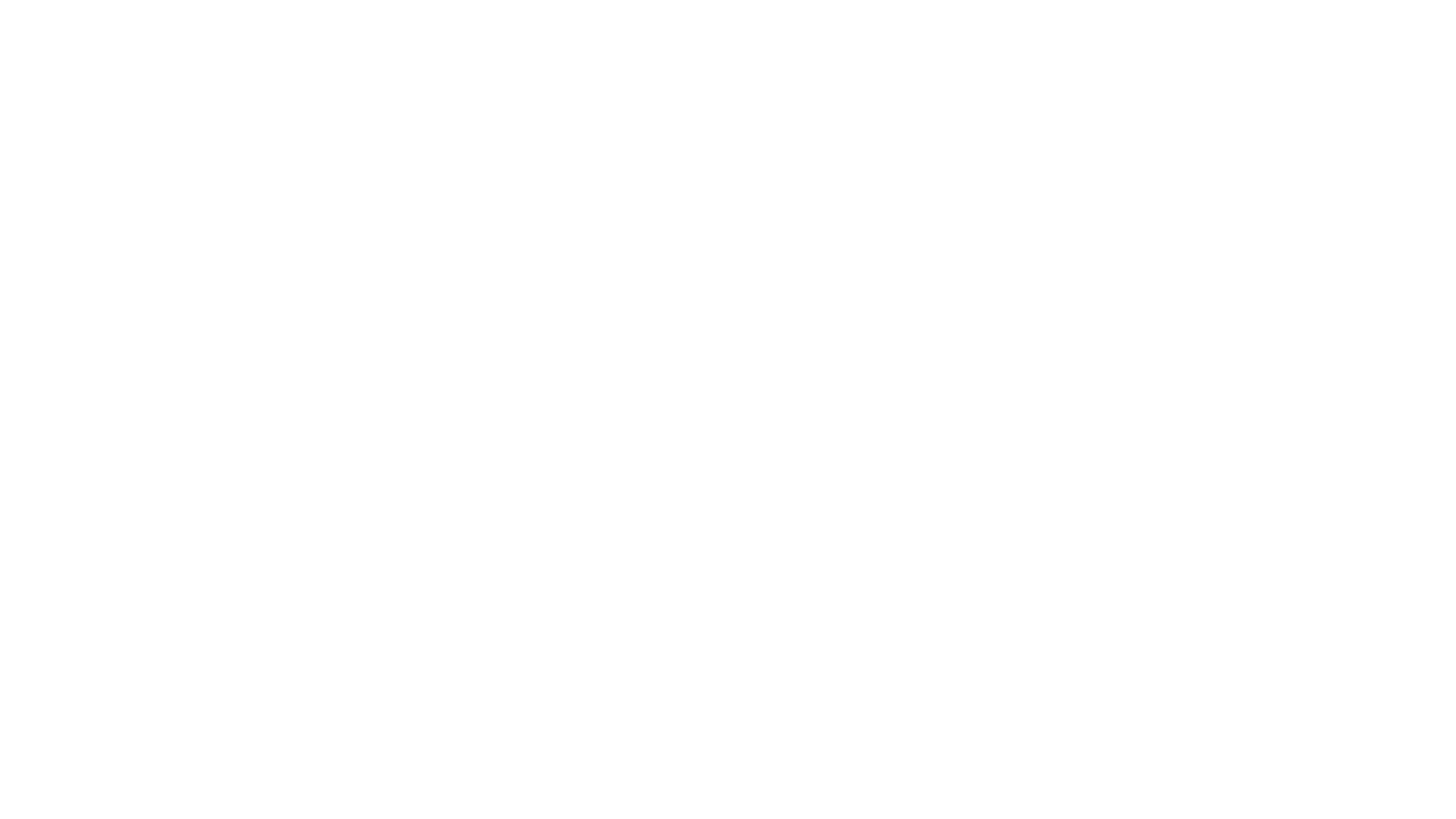اعتراف ستارمر بفلسطين يُظهر أن استقلالية بريطانيا عن أمريكا ترامب أمر حيوي

تحدّى رئيس الوزراء البريطاني واشنطن في دعمها غير المشروط لإسرائيل، مُظهرًا أن إعادة تقييم النظام العالمي باتت ضرورة ملحّة منذ زمن بعيد.
ففي الأحد الماضي، أعلنت بريطانيا رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، وهو القرار ذاته الذي اتخذته أستراليا والبرتغال وكندا.
وجاءت هذه الخطوة قبل انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 23 أيلول/ سبتمبر، حيث لحقت فرنسا وبلجيكا بالاعتراف بفلسطين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في إعلانه: “اليوم، ومن أجل إحياء أمل السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعترف بريطانيا رسميًا بدولة فلسطين”.
وربما، بالنظر إلى الغياب التام لأي نشاط دبلوماسي في هذا الاتجاه، يبدو أن قرار بريطانيا يهدف أكثر إلى إنقاذ حل الدولتين منه إلى إحيائه؛ ومع ذلك، فالرسالة السياسية الواضحة الصادرة من لندن هي أن سلامًا عادلاً ودائمًا للطرفين لا يمكن تحقيقه إلا عبر حل الدولتين، بغض النظر عمّا قد تراه القدس وواشنطن في هذه اللحظة.
لقد كان قرارًا متأخرًا بالنسبة لبريطانيا، فهي في الأصل مسؤولة عن ما يُسمى “القضية الفلسطينية” منذ أن أعلنت حكومتها عام 1917 نيتها دعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين عبر “وعد بلفور” المشؤوم.
وجاء القرار أيضًا بعد مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني في غزة على يد الجيش الإسرائيلي وقوات مرتزقة أمريكية، وبعد الكشف الصادم الذي يفيد – بحسب تقديرات جيش الاحتلال نفسه – أن 83% من الضحايا ربما كانوا مدنيين.
كان ستارمر قد لمح إلى قراره خلال الصيف حين أعلن أنه إذا لم تفِ إسرائيل بجملة من الشروط، أبرزها وقف إطلاق النار في غزة والتعهد بعدم ضم أي من أراضي الضفة الغربية المحتلة، فإن الاعتراف سيأتي لاحقاً.
لكن حكومة نتنياهو لم تكن تنوي الالتزام، بل على العكس، فهي منخرطة حاليًا في اجتياح بري واسع لمدينة غزة وتهجير سكانها، بينما يعلن كثير من وزرائها نيتهم ضم الضفة الغربية.
الدعم غير المشروط
منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ظلت الحكومة البريطانية تدعم أفعال إسرائيل في غزة بلا تحفظ، سواء في عهد حكومة المحافظين بقيادة ريشي سوناك، أو منذ تموز/ يوليو 2024 تحت قيادة حكومة حزب العمال برئاسة ستارمر.
فقد أعطت الحكومتان الأولوية للرواية الإسرائيلية وحقها المزعوم في الدفاع عن النفس على أي اعتبار آخر يتعلق بالقانون الدولي أو القانون الإنساني أو مبدأ التناسب في استخدام القوة، الذي انتهكته إسرائيل بشكل منهجي.
وعلى مدى أكثر من 18 شهرًا، لم تدفع أعداد الضحايا المدنيين الهائلة بين الفلسطينيين، ولا العدد غير المسبوق من الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية، ولا عمليات التهجير القسري المتكررة لسكان غزة، ولا الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، ولا قتل الجوعى العشوائي وهم في طوابير الطعام، إضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية على نطاق واسع، الحكومة البريطانية إلى تغيير موقفها المروّع.
لكن في الأشهر الأخيرة، أثرت عوامل عدة على حسابات السلطات البريطانية، منها تزايد أعداد الضحايا، وضغط الرأي العام والمجتمع المدني في بريطانيا، وقرارات محكمة العدل الدولية الأولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، إلى جانب لوائح الاتهام التي أصدرها القضاء الجنائي الدولي بحق قادة إسرائيليين كبار بتهم جرائم حرب.
ولستارمر، المحامي قبل أن يدخل عالم السياسة، يبدو أن حجم الأدلة القانونية المتراكمة بات من المستحيل تجاهله، رغم إنكاره أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بينما واجه ضغوطًا متزايدة من نواب حزبه.
وقد يكون عنصرًا إضافيًا في قراره هو التقرير الذي أصدرته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في 16 أيلول/ سبتمبر، والذي خلص إلى أن هناك أدلة قوية على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. ومن هنا، يستحق رئيس الوزراء البريطاني الثناء على هذا القرار التاريخي.
تحدٍ لواشنطن
إن انضمام أستراليا وكندا إلى بريطانيا ليس أمرًا عابرًا، فمع الولايات المتحدة ونيوزيلندا تشكل هذه الدول ما يُعرف بـ “العيون الخمس”، وهي مجموعة تدير عملية عالمية لجمع المعلومات الاستخبارية ومشاركتها بين الدول الأنجلوسكسونية، وتُعد أكثر أهمية من الناتو في هذا المجال.
وهذا يُظهر بوضوح أن هذه الدول الثلاث تجرأت على تحدي الولايات المتحدة في مسألة حساسة للغاية بالنسبة لواشنطن، وهي دعمها المطلق لإسرائيل.
ويُعد قرار بريطانيا أكثر أهمية بالنظر إلى سياق العلاقة الخاصة الممتدة لعقود بين واشنطن ولندن، حيث التزمت جميع الحكومات البريطانية تاريخيًا بقواعدها غير المكتوبة وتجنبت إزعاج الولايات المتحدة بخيارات مستقلة في السياسة الخارجية والأمنية.
وكانت آخر مرة ضغطت فيها بريطانيا على الولايات المتحدة قبل أكثر من عقدين، حين أقنع رئيس الوزراء توني بلير إدارة جورج بوش الابن بالسعي لاستصدار قرار من الأمم المتحدة لتغيير النظام في بغداد عام 2003، وهو ما فشل، ومضت واشنطن ولندن قدماً في الحرب بشكل غير قانوني.
وأخيرًا، اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية، وهو قرار يثير غضب حكومة نتنياهو إلى أقصى حد، في وقت تجلس فيه في واشنطن أكثر إدارة أمريكية مؤيدة لإسرائيل على الإطلاق. بمعنى آخر، وضع ستارمر سابقة مهمة قد تُستشهد بها في ملفات أخرى بالغة الحساسية.
تحديات أخرى
يواجه رئيس الوزراء البريطاني تحديين آخرين قد يحددان دور ومصالح بريطانيا على الساحة العالمية:
الأول هو العلاقة الحرجة بين أوروبا والولايات المتحدة، خاصة في ضوء المواقف المثيرة للجدل التي اتخذتها إدارة ترامب، ومنها فرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية.
والثاني هو مسألة لا تقل خطورة، وهي علاقة أوروبا مع الصين، في ظل نظام عالمي موازٍ (أو بديل) تعمل بكين على بلورته مع دول “بريكس” ومنظمة شنغهاي للتعاون، تجسّد في القمة الأخيرة التي عُقدت في تيانجين بالصين في الأول من سبتمبر.
كلا الملفين ينطويان على مصالح أكبر بكثير بالنسبة لبريطانيا.
فالأول، إلى جانب القضايا التجارية التي تسعى لندن لحلها بشكل منفصل مع واشنطن، يُعد أساسياً للتحالف عبر الأطلسي الممتد لعقود، خصوصاً في الجهود المبذولة لمساعدة أوكرانيا ضد الغزو الروسي، والتفكير في بناء هيكل أمني جديد في أوروبا، مع تراجع التزام واشنطن بالدفاع عن القارة.
أما الثاني، فيتعلق بعلاقة أوروبا مع أسرع منطقة اقتصادية نمواً في العالم وسوق ضخمة تفوق السوق الأمريكية، فضلاً عن تبعات النظام العالمي الجديد الذي تسعى دول “بريكس” ومنظمة شنغهاي إلى تنظيمه.
إملاءات واشنطن لأوروبا
إن خيار “إما أن تكونوا معي أو مع الصين” الذي تطرحه واشنطن على أوروبا، خيار يجب تفاديه بأي ثمن، لأن الأسواق الأمريكية لن تتمكن أبداً من استيعاب الأعمال التي قد تخسرها أوروبا إذا قررت الانفصال عن الصين.
حتى الآن، حرصت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي على عدم استفزاز إدارة ترامب، وفي الوقت ذاته تجنبتا القطيعة العلنية مع الصين.
لكن على لندن وبروكسل أن تضعا في الحسبان الرسالة المدمرة التي بعثت بها إدارة ترامب بشأن مدى موثوقيتها مع الحلفاء بعد القصف الإسرائيلي الصادم لقطر.
وربما آن الأوان لبريطانيا لاستكشاف مزايا استقلالها الاستراتيجي عن علاقة خاصة قديمة وغير ناجحة إلى حد كبير مع الولايات المتحدة، التي تبدو مهتمة فقط بمصالحها الخاصة حتى لو كان ذلك على حساب أقرب حلفائها، ناهيك عن التدخل العلني للحركات الأمريكية اليمينية المتطرفة الموالية لترامب في السياسة البريطانية من خلال دعمها الصريح لحزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج. وعملية إعادة التقييم ذاتها باتت مطلوبة الآن في بروكسل.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇