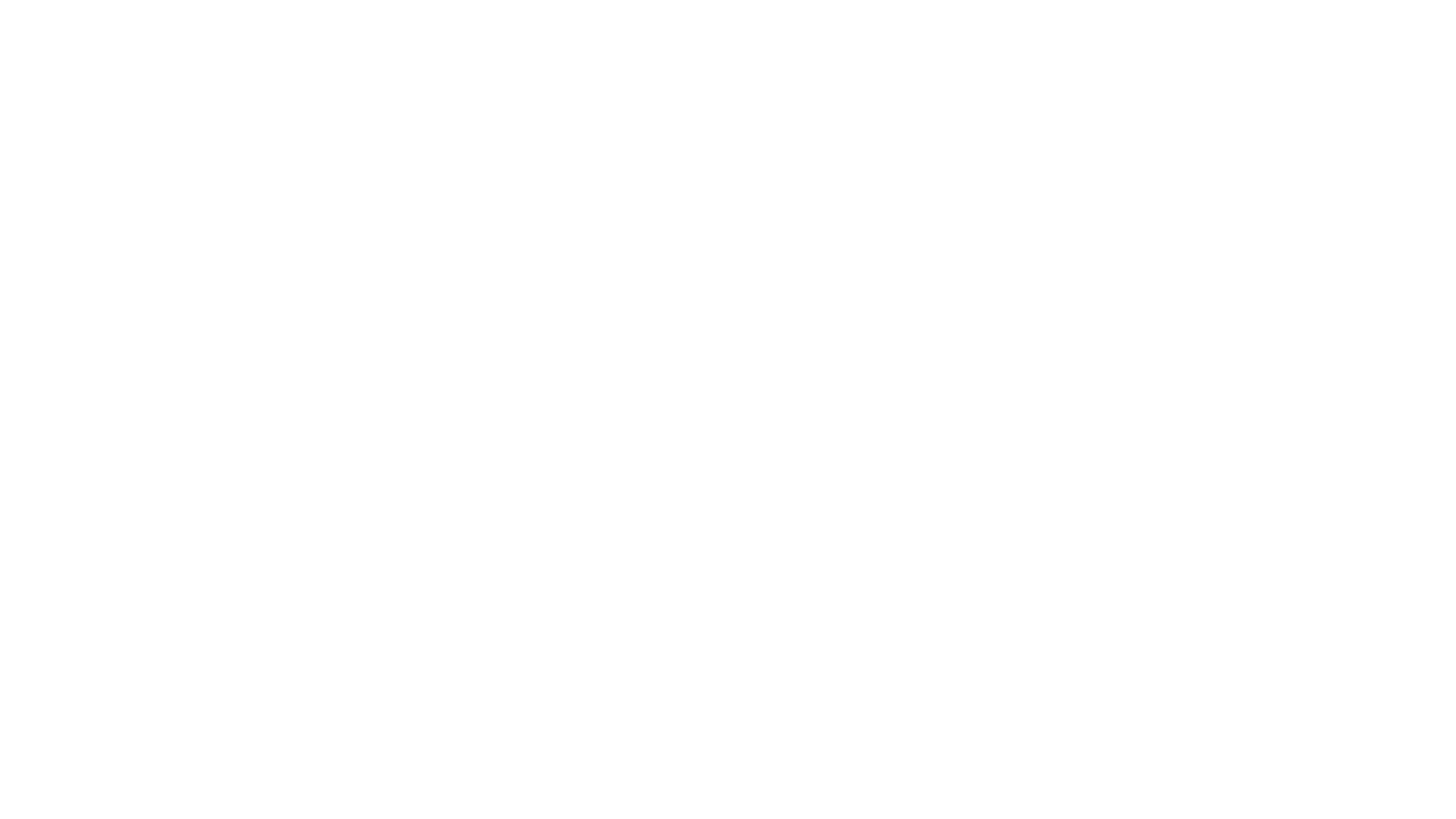من دمشق إلى غزة، قد تتحول خطة إسرائيل لتفتيت المنطقة إلى عامل موحّد يجمعها

لم تكن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على دمشق غارة جوية معزولة. لقد كانت عقيدة قيد التنفيذ.
في يوم الأربعاء، استهدفت الطائرات الحربية وزارة الدفاع السورية، والمقر العسكري، ومحيط القصر الرئاسي. ليس بالقرب من الجبهات أو الحدود، بل في القلب الرمزي والسيادي للعاصمة السورية.
كانت الذريعة واهية: جهد مزعوم لحماية أقلية الدروز في سوريا. لكن لا يجب أن ينخدع أحد.
لم يكن الأمر متعلقًا بالحماية. بل كان متعلقًا بإظهار القوة والغطرسة.
لم يكن عن الدروز – فهم عرب سوريون وجزء من النسيج الوطني السوري – بل عن فرض عقيدة إسرائيلية طويلة الأمد تقوم على تفتيت المنطقة، وتمتد من ركام غزة الملطخ بالدماء إلى الوزارات المقصوفة في دمشق وزعزعة استقرار دول بأكملها.
إسرائيل، التي قتلت أكثر من 60,000 فلسطيني – معظمهم من النساء والأطفال – في غزة، وجرحت أكثر من 130,000، ودمّرت ما يقرب من 80 في المئة من مباني القطاع، لا يمكنها أن تتظاهر الآن بأنها حامية للأقليات.
دولة تبني ما أصبح بسرعة أكبر معسكر اعتقال مفتوح في العالم، وتستخدم التجويع كسلاح، وتمارس الفصل العنصري اليومي في الضفة الغربية المحتلة وتكرّس التمييز في قانونها الأساسي، لا يمكنها أن تدّعي أي تفوق أخلاقي.
ليس لديها أي تفوق. لا سيما عندما يتعلق الأمر بادعاء القلق على دروز سوريا – الذين تستغل مصيرهم لإخفاء نوايا أكثر خبثًا.
عمل تلفزيوني للإذلال

لم يكن اختيار الهدف استراتيجيًّا. كان رمزيًّا.
ساحة الأمويين ليست مجرد تقاطع – إنها روح دمشق. إنها تمثل الفخر السوري والكرامة العربية. تحوي سيف دمشق وتصدح بتراث الخلافة الأموية، التي امتدت يومًا من البرانس إلى سهوب آسيا الوسطى. وفي هذه الساحة بالذات، احتفل السوريون قبل ثمانية أشهر فقط بسقوط ستة عقود من الديكتاتورية.
وكان هناك، في منتصف يوم عمل، حيث ضربت إسرائيل – مدركة أن الساحة محاطة بمحطات تلفزة عربية ودولية، وأن اللقطات ستُعاد مرارًا على شاشات القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.
لم تكن مجرد قصف. بل كان عملًا للإذلال المتلفز. أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ذلك حين شارك بفخر مقطعًا لمذيعة سورية مذعورة تهرب من أمام الكاميرا على الهواء بينما تحترق وزارة الدفاع في الخلفية.
كان عرضًا مسرحيًا صُمم لإخافة السوريين والعرب.
لم تكن هذه الضربة مجرد عمل غير قانوني أو غير أخلاقي، بل كانت خطوة جديدة في استراتيجية طويلة الأمد – عقيدة – تهدف إلى فرض الهيمنة الإسرائيلية على منطقة مجزّأة وضعيفة ومنقسمة.
وليست هذه العقيدة جديدة أو رد فعل عفوي. إنها أحد أعمدة الاستراتيجية الإسرائيلية، طُبقت عبر عقود، وحكومات، وحدود، وحروب. فمنذ الثورة في سوريا وسقوط نظام الأسد، نفذت إسرائيل ضربات على سوريا أكثر مما فعلت في جميع العقود السابقة مجتمعة.
فقد دمّرت البنية التحتية العسكرية بشكل منهجي، ونفذت مئات الغارات، ووسّعت احتلالها لمناطق استراتيجية، بما في ذلك سلاسل جبلية حيوية في جنوب سوريا.
أصبحت غاراتها الجوية روتينية، بل مملة – تهدف إلى تطبيع الانتهاك، ومحو السيادة، وتفكيك مكانة سوريا الإقليمية.
لكن الأمر يتجاوز الأفعال – إنه عقلية، بات قادة إسرائيل أكثر وضوحًا بشأنها. ففي اليوم التالي مباشرة لفرار الأسد، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “فكرة سوريا واحدة وذات سيادة هي فكرة غير واقعية”.
وذهب المحاضر العسكري رامي سيماني أبعد من ذلك: “سوريا دولة مصطنعة… يجب على إسرائيل أن تتسبب في اختفائها. وفي مكانها ستكون خمس كانتونات”.
وفي تصريح لا لبس فيه عن النية، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: “لن تنتهي المعركة حتى يغادر مئات الآلاف من سكان غزة… وتنقسم سوريا”.
ليست هذه مجرد خطابات. إنها سياسة. ويتم تنفيذها.
تقويض الوحدة العربية

تعود جذور هذه الاستراتيجية إلى أكثر من سبعة عقود، إلى ما يُعرف بـ”عقيدة الأطراف”، التي صاغها ديفيد بن غوريون وإيلياهو ساسون في السنوات الأولى من وجود إسرائيل.
كانت منطقها بسيطًا وقاسيًا: بما أن إسرائيل لا يمكنها الاندماج في العالم العربي، فستحيط به – من خلال بناء تحالفات مع قوى غير عربية (تركيا، إيران، إثيوبيا) واستغلال الانقسامات الداخلية داخل الدول العربية عبر تمكين الأقليات العرقية والدينية.
كان هدفها ثلاثيًّا: إقامة شراكات مع دول غير عربية ذات توجه غربي؛ تقويض الوحدة العربية من الداخل؛ وتعويض المعارضة الجماعية العربية لإسرائيل.
ساعدت هذه الاستراتيجية إسرائيل على البقاء والازدهار في سنواتها الأولى. لكنها لم تكن يومًا دفاعية. بل كانت توسعية. وقد قال بن غوريون ذلك بنفسه: “هدفنا هو تحطيم لبنان، شرق الأردن، وسوريا… ثم نقصف ونتقدم ونستولي على بورسعيد، والإسكندرية، وسيناء”.
وأضاف: “علينا أن نخلق دولة ديناميكية، موجهة نحو التوسع”. وقال أيضًا: “لا وجود لترتيب نهائي… لا فيما يخص النظام، ولا الحدود، ولا الاتفاقات الدولية”.
في مكان آخر، كان أكثر وضوحًا: “حدود الطموحات الصهيونية هي شأن الشعب اليهودي، ولا يمكن لأي عامل خارجي أن يحدّ منها”.
لم تكن هذه مجرد تأملات عابرة. بل كانت مبادئ تأسيسية. ولا تزال تحرّك السياسة الإسرائيلية حتى اليوم.
ومع تغير الديناميكيات الإقليمية، تغيرت أهداف إسرائيل. عقدت مصر اتفاق سلام. وسقط شاه إيران. وتقاربت تركيا مع الفلسطينيين.
كان لا بد للعقيدة أن تتطور.
لكن الهدف الأساسي – التفتيت – ظل ثابتًا. وقد طبقت إسرائيل هذه الوصفة في لبنان، وفي العراق، وفي السودان. غير أن سوريا تبقى الجوهرة في هذه الاستراتيجية.
لماذا؟ لأن سوريا هي أكبر دولة عربية مجاورة لفلسطين، ولأن السوريين لا يرون في فلسطين قضية خارجية، بل جزءًا من تاريخهم وجغرافيتهم وروحهم. كذلك، لأن بلاد الشام أكثر من مجرد جغرافيا – إنها ذاكرة مشتركة. ولأن إسرائيل تحتل أرضًا سورية.
لهذا قضت إسرائيل العقد الماضي في بناء علاقات مع مجتمعات كردية ودرزية – استعدادًا لاستخدامها في تفكيك مستقبلي. والآن، مع رحيل الأسد، ذلك المستقبل قد بدأ.
حسابات خاطئة قاتلة

لكن سوريا لم تعد النهاية. إنها مجرد مرحلة.
تمتد طموحات إسرائيل اليوم أعمق في “الهامش” الإقليمي، حيث أصبحت إيران وباكستان في مرماها المباشر.
خلال الحرب الأخيرة على إيران، دعت أصوات إسرائيلية – لا سيما في “جيروزاليم بوست” ومراكز الأبحاث المقربة من المحافظين الجدد – علنًا إلى تقسيم البلاد. أحد المقالات الافتتاحية حثّ ترامب على: “تبني تغيير النظام… وتشكيل تحالف شرق أوسطي لتقسيم إيران… وتقديم ضمانات أمنية للمناطق السنية والكردية والبلوشية الراغبة في الانفصال”.
واعتبرت “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” أن التعدد العرقي في إيران يجب أن يُعامل باعتباره نقطة ضعف استراتيجية يمكن استغلالها.
حتى باكستان باتت جزءًا من الرؤية. تتحدث أصوات مرتبطة بإسرائيل عن إعادة تشكيل المنطقة “من باكستان إلى المغرب”.
أما اتفاقيات أبراهام، فليست اتفاقيات سلام، بل أدوات لتطبيع هذا الطموح – من خلال وضع إسرائيل في موقع المركز الاقتصادي والأمني والتقني للمنطقة.
وأصبح المسؤولون الإسرائيليون أكثر صراحة. فقد قدّم سموتريتش رؤية لإسرائيل في قلب نظام إقليمي جديد – أشبه بـ”إمبراطورية حامية” – وصرّح بوضوح أن على الدول العربية “أن تدفع” لإسرائيل مقابل حمايتها من تهديدات مثل إيران وحماس.
الرسالة غير المعلنة واضحة: إسرائيل توفّر العنف، والجيران يدفعون الجزية.
هذا ليس تحالفًا، بل هيمنة مغلّفة بدبلوماسية.
وضع المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف الأمر بنبرة أكثر سلاسة: “إذا تعاونت كل هذه الدول، يمكن أن تكون أكبر من أوروبا… فهم منخرطون في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنية البلوك تشين… الجميع هناك رجال أعمال”.
هذا ليس اندماجًا. بل ضمّ: للاقتصاد، والسياسة، والسيادة. إنها خطة لبناء تكتل بقيادة إسرائيل يتجاوز أوروبا ويتحدى مراكز القوى العالمية.
لكن هنا يقع الخطأ القاتل في حسابات إسرائيل: كلما توسعت، زادت الأعداء.
تبدأ بالسعي للتحالفات في الهامش، وتنتهي بجعل ذلك الهامش معاديًا لها وجوديًّا.
أصبحت إيران، وتركيا، وباكستان – التي كانت خصومًا بعيدة – ترى إسرائيل الآن كتهديد مباشر.
وعبر العالم العربي، فإن إبادة غزة، وانتهاك دمشق، وهجمات بيروت وصنعاء وطهران، قد وحدت الشعوب كما لم تفعل أي قمة.
كلما تصرفت إسرائيل كإمبراطورية إقليمية، كلما رآها الإقليم كقوة استعمارية.
والإمبراطوريات الاستعمارية – كما يُذكّرنا التاريخ – لا تدوم.
ما تراه إسرائيل تفتيتًا قد يتحوّل إلى توحيد: توحيد في الغضب، والإدراك المشترك أن التهديد الحقيقي ليس إيران ولا سوريا ولا حتى الإسلام السياسي… بل عقيدة الهيمنة نفسها.
وتلك العقيدة – على عكس الصواريخ التي تطلقها إسرائيل اليوم – لن تمرّ بلا رد.
المستقبل الذي تحلم به إسرائيل – مستقبل الهيمنة والخضوع – ليس هو المستقبل الذي سيسمح به الإقليم.
لأن شعوب هذه المنطقة مرت من هنا من قبل. لقد تجاوزت إمبراطوريات، ودفنت صليبيين، ومستعمرين، وطغاة. وتعلمت أن العقيدة الوحيدة التي تستحق أن تُحمَل هي تلك التي تجمعهم… لا تفرّقهم.
قد ترسم إسرائيل خرائط، وتستغل أقليات، وتقصف العواصم، وتجوّع الأطفال – لكنها لا يمكنها أن تقصف طريقها نحو البقاء.
لا يمكنها إسكات المنطقة إلى الأبد.
ولا يمكنها بناء مستقبلها فوق أنقاض الآخرين – لأن تلك الأنقاض… تتذكّر.
والذاكرة، في هذه الأرض، ليست جرحًا… بل سلاح.
المصدر: بي بي سي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇