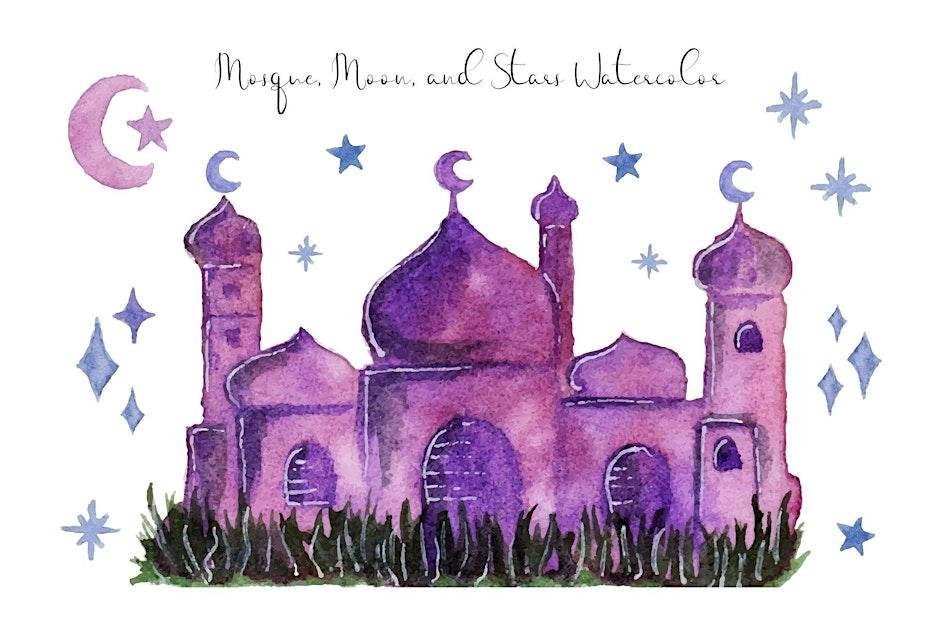السّعي في طلب العلم بالمهجّر

الهجرة إعادة صياغةٍ للذات، وولادةٌ ثانيةٌ للإنسان في فضاءٍ جديدٍ يفرض عليه أن يعيد ترتيب أولويّاته، ويختبر قدرته على التّكيّف والصّبر والمثابرة، وفي قلب هذا المخاض العسير، يتجلّى طلب العلم بوصفه واحداً من أنبل السّبل الّتي يسلكها المهاجر، بل هو السّعي الّذي يحوّل الغربة إلى فرصةٍ، والشّتات إلى مساحةٍ للنّموّ والارتقاء.
في الوطن، قد يكون طلب العلم امتداداً طبيعيّاً لخطٍّ مرسومٍ منذ الصّغر، تدعمه العائلة والمجتمع والمحيط المألوف. أمّا في المهجّر، فإنّ العلم يتحوّل إلى مغامرةٍ كبرى، وإلى تحدٍّ يوميٍّ يواجه فيه المهاجر اختلاف اللّغة وصعوبة الاندماج وتقلّب الظّروف الاقتصاديّة والنّفسيّة.
هنا تتجلّى قيمة السّعي، فالعلم لا يُنال بيسرٍ وسهولةٍ، إنّما يُطلب بإرادةٍ أقوى من الحنين، وبصبرٍ يتجاوز الألم، وبشغفٍ يُعيد للإنسان معنى وجوده في عالمٍ جديد.
الغربة تُعلّم المهاجر أن الزمن رأس المال الحقيقيّ، وأنّ استثماره في طلب العلم هو الطّريق الأصدق لإثبات الذات؛ فالمهاجر الّذي يُقبل على الدّراسة يطلب معنى، يبحث عن اعترافٍ بقدرته على المساهمة في بناء المجتمع الجديد، ويبرهن لنفسه أوّلاً ولمن حوله أنّ الانقطاع عن الأرض لا يعني الانقطاع عن الرّسالة.
العلم في المهجّر إعادة بناءٍ للهويّة في ضوء معارف أوسع وتجارب أعمق.
ولعلّ أجمل ما في طلب العلم بالمهجّر أنّه يجمع بين بعدين متكاملين: البعد الفرديّ والبعد الجماعيّ؛ فعلى الصّعيد الفرديّ، يمنح العلم للمهاجر قدرةً على التّحرّر من قيود التّبعيّة والاعتماد، ويصنع له مكانةً تقيه الهشاشة وتفتح أمامه أبواب العمل والإبداع، أمّا على الصّعيد الجماعيّ، فإنّ المهاجر المتعلّم يصبح وسيلة وصلٍ بين ثقافتين، ينقل خبراته إلى مجتمعه الأصليّ حين يعود أو حين يتواصل معه، ويسهم في الوقت نفسه بإغناء المجتمع المضيف عبر ما يضيفه من اجتهاداتٍ وأفكارٍ.
وبهذا يتحوّل العلم إلى لغةٍ عالميّةٍ قادرةٍ على اختصار المسافات الّتي تصنعها السّياسة أو الحدود.
إنّ السّعي في طلب العلم بالمهجّر يحتاج إلى شجاعةٍ خاصّةٍ، فالمغترب يبدأ من نقطةٍ أدنى ممّا كان عليه في وطنه.
قد يجد نفسه طالباً في صفوفٍ أولى بعد أن كان متفوّقاً في جامعته، أو متعلّماً لغةً جديدةً بعدما أتقن لغته الأمّ.
هذا الانكسار الظّاهر قد يبدو محبطاً في البداية، لكنّه في الحقيقة شرارةٌ أولى لرحلة نهوضٍ جديدةٍ؛ فالعلم لا يعرف الغرور ولا الكبرياء، ومن تواضع له أُعطي، ومن صبر عليه فُتح له.
ولقد شهد التّاريخ أنّ الهجرة كانت من أعظم عوامل النّهضة العلميّة؛ فكم من عالمٍ رحل عن بلده طلباً للعلم أو فراراً من قمعٍ أو تضييقٍ، فإذا به في غربته يصوغ أعظم الأفكار وينشر أنوار المعرفة.
يكفي أن نتأمّل سيرة العلماء المسلمين الّذين جابوا البلدان طلباً للحديث والفقه والفلسفة، أو نتذكّر علماء العصر الحديث الّذين خرجوا من بلادهم مثقّلين بالمعاناة، لكنّهم عادوا أو استقرّوا وهم يحملون في عقولهم ما رفع من شأن أممٍ بأكملها.
المهاجر الّذي يسعى للعلم في غربةٍ قاسيةٍ يشبه شجرةً نُقلت من تربةٍ ضيّقةٍ إلى فضاء أرحب، لكنّها تحتاج إلى وقتٍ طويلٍ كي تثبّت جذورها وتُثمر.
قد تمرّ عليها رياحٌ قاسيةٌ وشتاءات مظلمةٌ، غير أنّ إصرارها على الامتداد في الأعماق يضمن لها أن تصمد وتثمر في النّهاية.
كذلك هو طالب العلم في المهجّر؛ يغلبه التّعب أحياناً، ويعانده اليأس أحياناً أخرى، لكنّ عزيمته وإيمانه بأنّ العلم هو الطّريق الأقصر للكرامة والارتقاء تجعله يستمرّ.
إنّ الهجرة في جوهرها اختبارٌ للإرادة، والعلم في عمقه اختبارٌ للعقل، وعندما يجتمعان في قلب المهاجر، يتكوّن إنسانٌ جديدٌ قادرٌ على أن يحوّل محنته إلى منحةٍ، وغربته إلى مدرسةٍ. وما أجمل أن تكون الغربة لا نهاية مسدودة، إنّما بداية لصعودٍ جديدٍ، وما أعمق أن يكون العلم في المهجّر ليس مجرّد وسيلةٍ للنّجاة، إنّما رسالة للوجود.
ومن المثير في طلب العلم بالمهجّر أنّه بناءٌ مستمرٌّ للذات، وتثبيتٌ للهويّة في قلب الغربة؛ فالمهاجر الّذي يسعى للعلم يتعلّم كيف يوازن بين ماضيه وحاضره، بين جذوره وامتداده إلى فضاءٍ جديد، إنّه يتعلم كيف يكون صبوراً أمام صعوبات اللّغة، وكيف يواجه العزلة والاغتراب بالانغماس في المعرفة والعمل.
كلّ يومٍ يمرّ به في الدّراسة أو البحث يمثّل تحديّاً جديداً، وكلّ نجاحٍ صغيرٍ هو شهادةٌ على قدرة الإنسان على الصّمود والتحوّل.
والغربة، في هذا السّياق، تتحوّل من شعورٍ بالافتقاد إلى فرصةٍ للتعمّق في النّفس، وفهم العالم بعيونٍ جديدةٍ؛ فالمهاجر الّذي يتعلّم ويقرأ ويبحث، يكتسب أدوات تساعده على التفهّم والتّقدير، ليس فقط للثّقافات الأخرى، بل لنفسه ولقدراته، كما يكتشف أنّ العلم يُعطيه حريّة التّفكير، وأنّ المعرفة تجعل من الممكن أن يكون جزءاً فعّالاً من المجتمع المضيف، وأن يسهم في التّغيير الإيجابيّ أينما وجد.
وعندما يُنهي المهاجر دراسةً أو مشروعاً أو بحثاً، لا يكون قد حقق إنجازاً شخصيّاً فحسب، بل يصبح نموذجاً يُحتذى به للآخرين، ويصبح بحقٍّ وسيلة وصلٍ بين وطنه الأصليّ والمجتمع الجديد، حاملاً معه قيمه ومبادئه ومعارفه التّي يمكن أن تثري كلّ من حوله. هكذا يصبح طالب العلم في المهجّر رمزاً للأمل والتحدّي، ومثالاً يُحتذى به على قدرة الإنسان على تحويل الظّروف الصّعبة إلى فرصٍ عظيمةٍ.
إنّ رحلة طلب العلم في المهجّر تعلّم الإنسان كيف يكون مرناً، وكيف يحوّل الفشل إلى درسٍ، واليأس إلى دفعةٍ نحو الأمام، والصّعاب إلى مصادر إلهامٍ؛ إذ إنّ المهاجر الّذي يستثمر وقته وجهده في العلم يُثبت لنفسه قبل الآخرين أنّ الإرادة تصنع الفارق، وأنّ العقل المتفتّح هو الّذي يقدّم الحلول ويصنع الفرص.
وفي نهاية المطاف، يصبح العلم في المهجّر رسالةً للحياة بأسرها، رسالةٌ تقول إنّ الإنسان قادرٌ على تحويل غربته إلى مدرسةٍ، وصعوبة الرّحيل وعقباته إلى طريقٍ نحو النّور والمعرفة، وبأنّ لكلّ تحدٍّ في الحياة قيمة تُعلّمنا كيف نكون أفضل، كيف نرتقي، وكيف نترك أثراً يُخلّد ذكراه في عقول وقلوب من حولنا.
اقرأ أيضًا:
- كيف يستوعب الإنسان تجربة المهجّر؟
- أهميّة استثمار الوقت في المهجر
- كيف تصنع الطيبة جسرا للاندماج في المهجر؟
جميع المقالات المنشورة تعبّر عن رأي أصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المنصة
الرابط المختصر هنا ⬇