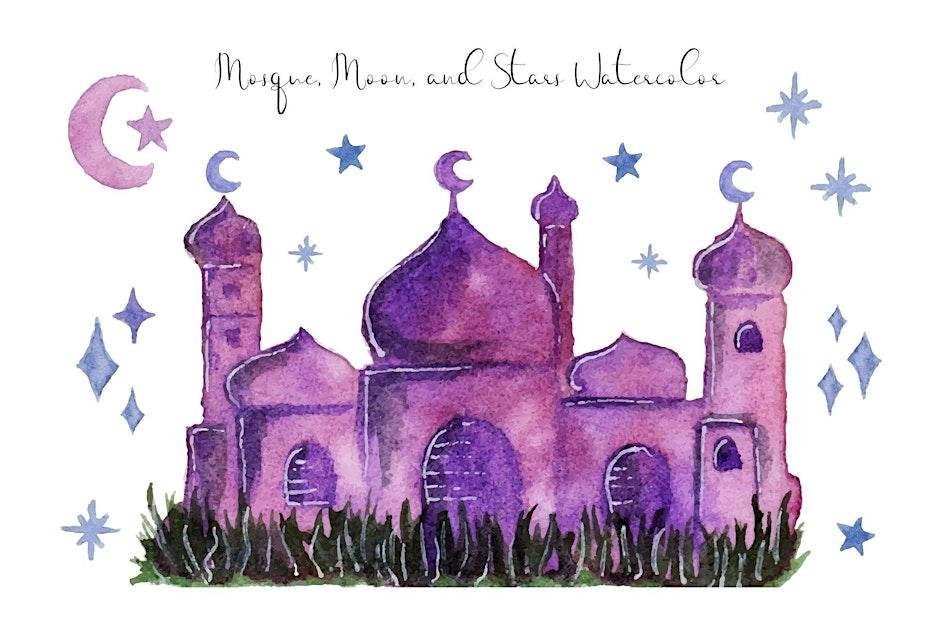الذاكرة كأداة سلطة: من يكتب التاريخ يملك المستقبل

الذاكرة طاقة فاعلة تُعيد تشكيل وعي الفرد والجماعة. فما نحتفظ به في الذاكرة لا يرسم صورة الماضي فحسب، وإنّما يحدّد زاوية النّظر إلى الحاضر، ويرسم ملامح الممكن في المستقبل. ولهذا، لم تكن كتابة التاريخ يوماً فعلاً بريئاً خالصاً؛ إنّها ممارسة مشتبكة بالقوة، بالاختيار، وبالقدرة على توجيه الوعي عبر الزمن. فعندما تُصاغ السرديات الكبرى، لا يُدوَّن ما جرى فقط، فيُقرَّر أيضاً ما ينبغي أن يُنسى، وما يجب أن يُضخَّم، وما يُمنح صفة اللحظة المؤسسة لهوية شعب أو أمة.
فالتاريخ بناء سردي يتشكّل بالكلمات والصور والتأويلات. والسلطة، أياً كان شكلها، تدرك أن الهيمنة على السردية التاريخية تمنح نفوذاً يتجاوز حدود الحاضر. فمن يعيّن الأبطال، وينتقي لحظات المجد، ويعيد تفسير الهزائم، يستطيع أن يوجّه نظرة المجتمع إلى ذاته. وغالباً ما يتم هذا التوجيه في صيغ ناعمة وغير مباشرة: عبر المناهج التعليمية، أو الأعمال الفنية، أو الطقوس والاحتفالات الوطنية التي تعيد إنتاج رواية بعينها عن الماضي.
ولا تتكوّن الذاكرة الجماعية من الوقائع وحدها، ولكن من الكيفية التي تُقدَّم بها. فالحرب، مثلاً، قد تُروى بوصفها بطولةً لا بدّ منها، أو مأساةً إنسانية، أو صراعاً عبثياً، تبعاً لزاوية الرؤية والجهة التي تمسك بخيوط السرد. هنا يتحوّل التاريخ إلى ساحة صراع على المعنى، لا إلى سجل جامد للأحداث. وكلما امتلكت جهة ما أدوات التعليم والإعلام، ازدادت قدرتها على تثبيت رؤيتها في الوعي العام.
غير أن أخطر وجوه الذاكرة السلطوية لا يكمن فيما تكتبه فقط، وإنّما نعم فيما تختار إقصاءه. فالتاريخ قد يُعاد تشكيله عبر النسيان الانتقائي؛ بحذف أحداث كاملة، أو اختزالها إلى هوامش باهتة، حتى تتلاشى تدريجياً من الوعي الجمعي. ومع الزمن، يتحوّل الغياب إلى حقيقة، ويغدو ما لم يُذكر كأنه لم يكن. وهكذا تتشكّل ذاكرة ناقصة، لا لأنها كاذبة تماماً، ولكن لأنها مبتورة.
وفي المقابل، لا يمكن اختزال كل كتابة للتاريخ في منطق السيطرة والتلاعب. فهناك دائماً باحثون ومفكرون يسعون إلى قراءة الماضي بأقصى ما يستطيعون من نزاهة. ومع ذلك، حتى أكثر المقاربات موضوعية تظل مشدودة إلى سياقها الثقافي والسياسي؛ فكل جيل يعيد طرح أسئلته الخاصة على التاريخ، ويؤوّله وفق قضاياه الراهنة. ومن هنا، لا يبدو التاريخ نصاً مغلقاً، بل عملية مستمرة من المراجعة وإعادة الفهم.
ومع التحول التكنولوجي، دخلت الذاكرة طوراً جديداً. فقد أفرزت وسائل التواصل الاجتماعي أرشيفاً هائلاً ومفتوحاً، لكنها في الوقت ذاته جعلت السرديات أسرع وأكثر تشظياً. فالأحداث تُفسَّر لحظة وقوعها، وتُعاد صياغتها آلاف المرات خلال ساعات. وهذا يفتح المجال لتعدّد الأصوات، لكنه يسهّل أيضاً صناعة التضليل والروايات الزائفة. في هذا الفضاء الرقمي، لم تعد السيطرة على الذاكرة حكراً على الدول والمؤسسات الكبرى؛ ولكن غدت مهارة التأثير الإعلامي أداة حاسمة في تشكيل الوعي.
ومع ذلك، تظل الذاكرة ساحة مقاومة بقدر ما هي مجال للهيمنة. فالأفراد والجماعات قادرون على استعادة قصصهم المقصاة، وصياغة روايات بديلة تكشف زوايا طال إهمالها. وقد شهد العالم حركات أعادت فتح ملفات تاريخية مغلقة، وغيّرت طرق فهم الماضي. وهذا يؤكد أن الذاكرة ليست ملكاً للسلطة وحدها، وإنما مجال صراع وحوار دائمين.
هنا يبرز دور الكاتب والمثقف، بوصفه محايداً شريكاً في تشكيل الوعي الجمعي. فاختيار المفردات، وبناء السرد، وتحديد زاوية النظر، كلها عناصر تصوغ صورة الماضي في أذهان الأجيال القادمة. والكتابة المسؤولة لا تدّعي حياداً مطلقاً، بل تعترف بالتعدّد، وتنفتح على الروايات المختلفة، وترفض اختزال التاريخ في خطاب دعائي.
كما أن القارئ ليس متلقياً سلبياً. فحين يقرأ التاريخ بعقل نقدي، ويتساءل عن مصادر الروايات وسياقاتها، يصبح شريكاً في حماية الذاكرة من الاحتكار. فالقراءة الواعية تُحصّن المجتمع ضد التلاعب، وتمنحه قدرة أعمق على بناء فهم متوازن للماضي، بما ينعكس نضجاً في قرارات الحاضر.
إن المقولة القائلة إن من يكتب التاريخ يملك المستقبل تنطوي على حقيقة عميقة؛ لأن المستقبل يُبنى على الصور التي يحملها الناس عن ذواتهم وتجاربهم السابقة. فالأمة التي ترى تاريخها سلسلة متصلة من الانتصارات قد تقع في وهم الغرور، وتلك التي لا ترى فيه إلا الهزائم قد تفقد ثقتها بذاتها. أما الأمة التي تواجه ماضيها بصدق، وتعترف بإنجازاتها وأخطائها معاً، فهي الأقدر على صناعة مستقبل متوازن.
في النهاية، الذاكرة قوة حيّة تشكّل الحاضر وتمتد بظلالها إلى الغد. ويمكن أن تكون أداة هيمنة تُفرض من الأعلى، أو مجالاً مفتوحاً للحوار والنقد. والفارق بين الوجهين رهن بوعي المجتمع وقدرته على مساءلة السرديات السائدة. فعندما يُفتح التاريخ على التفكير، لا يُقدَّس كنص مغلق، تتحوّل الذاكرة من وسيلة للسيطرة إلى مصدر للتعلّم والتحرّر.
وهكذا، فإن كتابة التاريخ ليست فعل توثيقٍ فحسب، هي مسؤولية أخلاقية تجاه المستقبل. فالكلمات التي تُكتب اليوم ستغدو غداً جزءاً من وعي أجيال لم تولد بعد. ومن هنا يظل السؤال حاضراً: كيف نروي الماضي؟ ولماذا؟ وبأي قدر من الصدق والشجاعة؟ لأن الإجابة عنه هي ما يحدّد إن كانت الذاكرة ستبقى أداة سلطة تُوجّه الإنسان، أم جسر فهمٍ يعينه على بناء مستقبل أكثر وعياً وإنصافاً.
اقرأ أيضًا:
- المتحف البريطاني.. حينما يغتال “التاريخ” جغرافيا الحقيقة
- كيف يولد النّجاح في بيئةٍ تُتقن صناعة الفشل؟
- ضريبة الثبات في زمن “السيولة” الأخلاقية… هل أنت قادر على دفعها؟
جميع المقالات المنشورة تعبّر عن رأي أصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المنصة
الرابط المختصر هنا ⬇