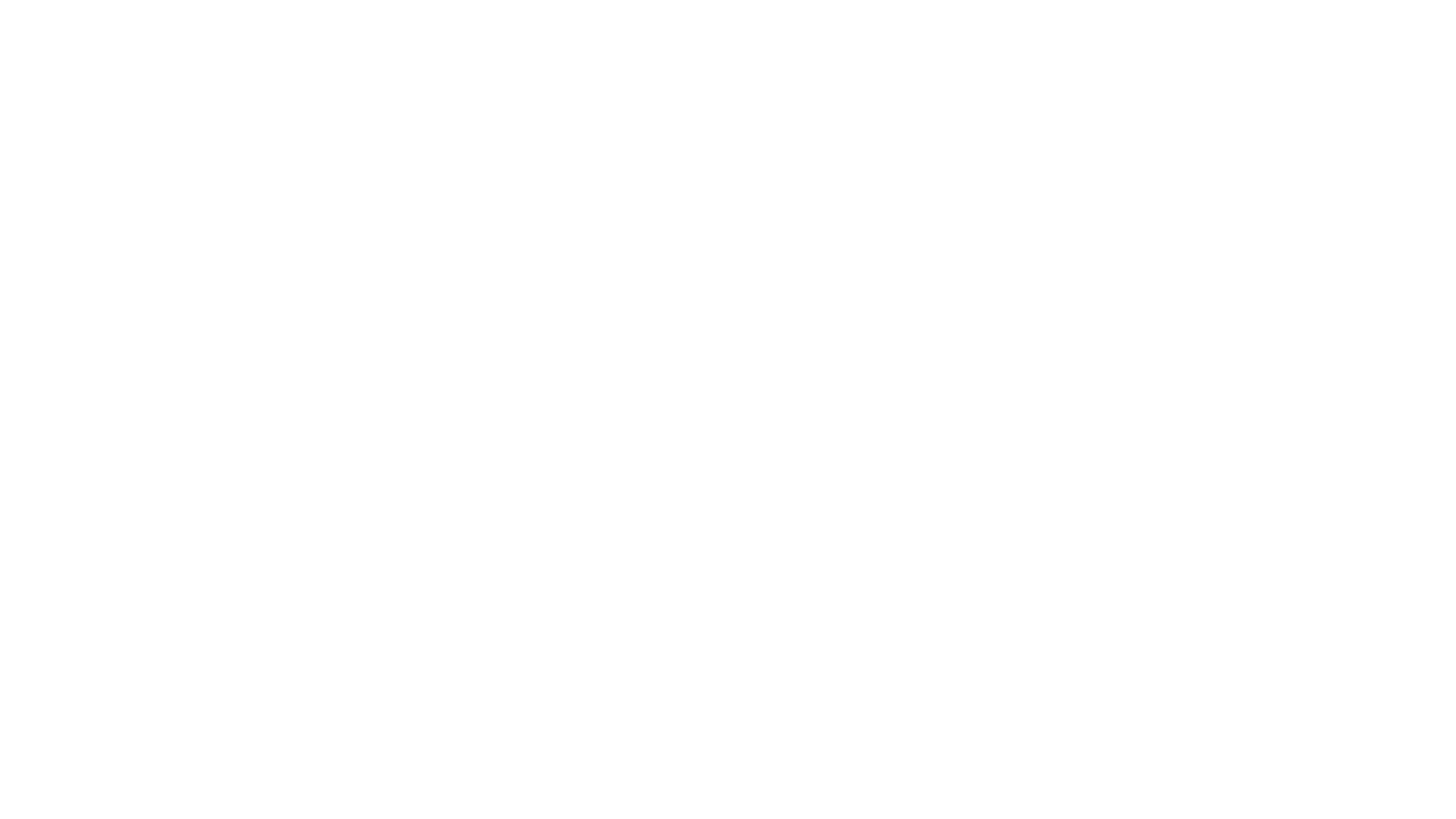لماذا لا تُحبّ العينُ الحاجب؟ تأمّل في المسافات الخفيّة بين الناس

جلستُ إلى جوار جدّي، قريبةً من مدفأة الحطب، أمدّ أصابعي المرتجفة نحو دفءٍ صغير يشبه الطمأنينة، وأصغي إلى صوت الحطب وهو يتكسّر كأنّه يروي حكاياتٍ أقدم من الشتاء نفسه. كان المساء ساكناً حدّ أنّ الصمت بدا وكأنّه يجلس معنا، يشاركنا دفءَ اللحظة، بينما كان البرد يطرق النوافذ في الخارج كضيفٍ ثقيل لا يعرف الاستئذان.
في تلك اللحظة، التفت إليّ جدّي وسألني فجأة:
«لماذا لا تُحبّ العينُ الحاجب؟»
كان السؤال بسيطاً إلى حدّ الحيرة. شعرتُ أنّه أُلقي في داخلي كما تُلقى حصاة في ماءٍ ساكن، فتتّسع دوائره بلا إجابة. قلتُ:
«لا أعلم.»
ابتسم ابتسامةً خفيفة تشبه حكمة المواقد القديمة، وقال:
«أعيد سؤالي، لماذا لا تُحبّ العينُ الحاجب؟»
بعد صمتٍ أجبته:
«في الحقيقة لا أعلم.»
أجابني بصوتٍ هادئ:
«لأنّ الحاجب أعلى منها ولن تصل إليه يوماً مهما حاولت… ولذلك لن تحبّه. ولهذا، على الحاجب أيضاً ألّا ينتظر حبّها.»
توقّف قليلاً، وكأنّه يترك للكلمات وقتاً كي تستقرّ في داخلي، ثمّ أضاف:
«تذكّري جيداً: العين لا تُحبّ الحاجب ولن تحبّه، لأنّه أعلى منها ولن تصل إليه.»
لم أفهم يومها أنّ تلك الجملة الصغيرة كانت بذرة فكرةٍ ستنمو داخلي أيّاماً طويلة. ظننتها حكمةً عابرة تُقال، لكنّ الزمن وحده يعرف كيف يعيد الكلمات إلى أصحابها في اللحظة التي نصبح فيها قادرين على فهمها.
كبرتُ، وكبرت معي تلك الجملة قبل أن أعلم معناها من جدّي. ومع كلّ تجربة، كانت تعود إليّ بصيغةٍ جديدة، وكأنّها كانت تتبدّل مع اتّساع رؤيتي للحياة. أدركتُ بعد وقتٍ أنّ جدّي لم يكن يتحدّث عن عينٍ وحاجبٍ، بل عن الناس. عن تلك المسافات الخفيّة التي لا تُرى، لكنّها تفصل بين القلوب أكثر ممّا تفعل الجغرافيا.
ليست كلّ المسافات تُقاس بالكيلومترات.
بعضها يُقاس بالعلوّ، وبعضها بالكبرياء، وبعضها بالصمت الذي لا يُقال.
كم من أشياء تبدو قريبةً منّا حدّ الظنّ أنّها جزءٌ من حياتنا، لكنّها في الحقيقة بعيدةٌ حدّ استحالة لمسها؟ نراها كلّ يوم، نمرّ بجانبها، نعتقد أنّها في متناول أيدينا، لكنّها تبقى خارج مدى الوصول.
وهكذا هي بعض العلاقات، وبعض النجاحات، وبعض الأحلام:
نراها واضحةً أمامنا، لكنّ الطريق إليها لا يراه إلّا من سار فيه.
مع مرور الوقت، فهمتُ أنّ الناس لا ينظرون إلى الطريق الذي صعدناه، ولكن إلى المكان الذي وصلنا إليه. يرون القمّة، ولا يرون الدرج. يرون النتيجة، ولا يرون التعب. يرون العلوّ، ولا يرون الثمن الذي دُفع في صمت.
وحين تختصر العيون الرحلة الطويلة في مشهدٍ واحد، يبدأ سوء الفهم.
فمن يقف في الأسفل لا يرى السهر، ولا الخسارات، ولا لحظات الشكّ، ولا الانكسارات الصغيرة التي مهّدت لكلّ خطوةٍ إلى الأمام. يرى فقط شخصاً يقف في الأعلى، فيظنّ أنّ العلوّ حدث فجأة، أو أنّه امتيازٌ بلا ثمن.
وهنا تبدأ المسافة الحقيقية.
هذه المسافة ليست بين شخصين فحسب، هي بين رؤيتين للحياة:
رؤية ترى الطريق، ورؤية ترى النتيجة.
في كثيرٍ من الأحيان، لا تتحوّل النظرة نحو الأعلى إلى إعجاب، وإنّما إلى غصّة. ومع الوقت، تتحوّل الغصّة إلى غيرةٍ صامتة لا تعترف باسمها. ليست غيرةً معلنة بقدر ما هي شعورٌ خفيّ يتسلّل إلى النظرات والكلمات والتأويلات.
ونكتشف هنا أنّ الغيرة لا تولد من الكراهية، بل من المقارنة.
والمقارنة لا تولد من البعد، بل من القرب الذي لا يمكن تجاوزه.
كما أنّ الناس لا يغارون ممّن يعيشون في عوالم بعيدةٍ عنهم، وإنّما ممّن يقفون قريباً منهم، لكن أعلى منهم بدرجةٍ أو درجتين. لأنّ هذا الارتفاع يبدو ممكناً… ومع ذلك لم يحدث لهم.
وهنا تحديداً تتجلّى حكمة جدّي:
العين ترى الحاجب كلّ يوم، قريباً جداً، لكنّها لا تستطيع أن تكونه.
ترى مكانه، ولا ترى الطريق إليه.
ترى صورته، ولا ترى قصّته.
وهكذا تتحوّل المسافة الصغيرة إلى مسافةٍ هائلة.
مسافة لا تُقاس بالأمتار، بل بالشعور.
فبعض الناس، حين يعجزون عن الصعود، لا يسألون عن الطريق… يسألون: لماذا ارتفع غيري؟
بدل أن يبدؤوا الرحلة، يبدأون تفسير العلوّ بطرقٍ مريحة لقلوبهم: صدفة، حظ، ظروف، دعم، أيّ شيءٍ إلا الاعتراف بأنّ الطريق موجود لكنه طويل.
وهذا فهمٌ لطبيعتهم. فالاعتراف بأنّ الطريق مفتوح يعني الاعتراف بأنّنا مسؤولون عن عدم سلوكه. وهذه مسؤولية ثقيلة لا يحبّها كثيرون.
لذلك، يصبح لوم العلوّ أسهل من بدء الصعود.
هنا فهمتُ لماذا قال جدّي إنّ الحاجب لا ينبغي له أن ينتظر حبّ العين. فليس كلّ من يراك مرتفعاً سيحبّك. بعضهم سيحبّك حقّاً، وبعضهم سيُعجب بك، وبعضهم سيتجاهلك، وبعضهم سيحاول إقناع نفسه أنّ ارتفاعك مبالغٌ فيه.
هذه طبيعة المسافات حين تصبح مرئيّة.
فالعلوّ، مهما كان بسيطاً، يغيّر زاوية الرؤية. وما نراه طبيعياً من موقعنا قد يبدو استثناءً لمن ينظر إلينا من الأسفل.
لكنّ الحقيقة الأعمق التي تعلّمتها لاحقاً هي أنّ الغيرة ليست المشكلة الحقيقية. المشكلة أنّها تُساء فَهمها. فالغيرة إشارةٌ إلى رغبةٍ مؤجّلة. إلى حلمٍ لم يُسلك طريقه بعد.
هي طاقةٌ يمكن أن تتحوّل إلى صعود، أو إلى مرارة.
ومن يختار الصعود، يكتشف أنّ القمّة ليست مكاناً، ولكن هي رحلة. وأنّ كلّ من يقف في الأعلى كان يوماً ما في الأسفل، يرفع رأسه ويتساءل: هل يمكنني الوصول؟
في نهاية المطاف، عدتُ إلى تلك الليلة الشتوية، إلى المدفأة، إلى صوت الحطب وهو يتكسّر، وإلى ذلك السؤال البسيط الذي بدا يومها بلا معنى.
أدركتُ أنّ جدّي لم يكن يعلّمني عن العين والحاجب، بل عن الحياة. عن المسافات التي لا نراها، وعن الارتفاع الذي لا يُقاس بالأمتار، بل بالرحلات التي خضناها كي نصل.
ومنذ ذلك الحين، صرتُ أؤمن أنّ أسوأ ما قد يحدث للقلب ليس الفقد فقط… وإنّما أن يبقى قريباً من شيءٍ لا يستطيع بلوغه. يراه كلّ يوم، ويعجز كلّ يوم عن الوصول إليه.
الناس لا يغارون ممّا يلامسونه…
بل ممّا يرونه بعيداً عن متناول أيديهم.
وبين من يرفع رأسه ليصعد، ومن يتعب من رفعها فيلوم العلوّ… تتشكّل الحكايات التي لا تُروى، والمسافات التي لا تُقاس، والقلوب التي تتعلّم — متأخّرةً — لماذا لا تُحبّ العينُ الحاجب.
اقرأ أيضًا:
- موقفٌ واحدٌ يَكفي لتعرف صديقك الحقيقي
- جزيرة إبستين: حين تحوّل الانحطاط إلى نظامٍ محمي
- وقفة تأمل في المشهد العربي المعاصر
جميع المقالات المنشورة تعبّر عن رأي أصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المنصة
الرابط المختصر هنا ⬇