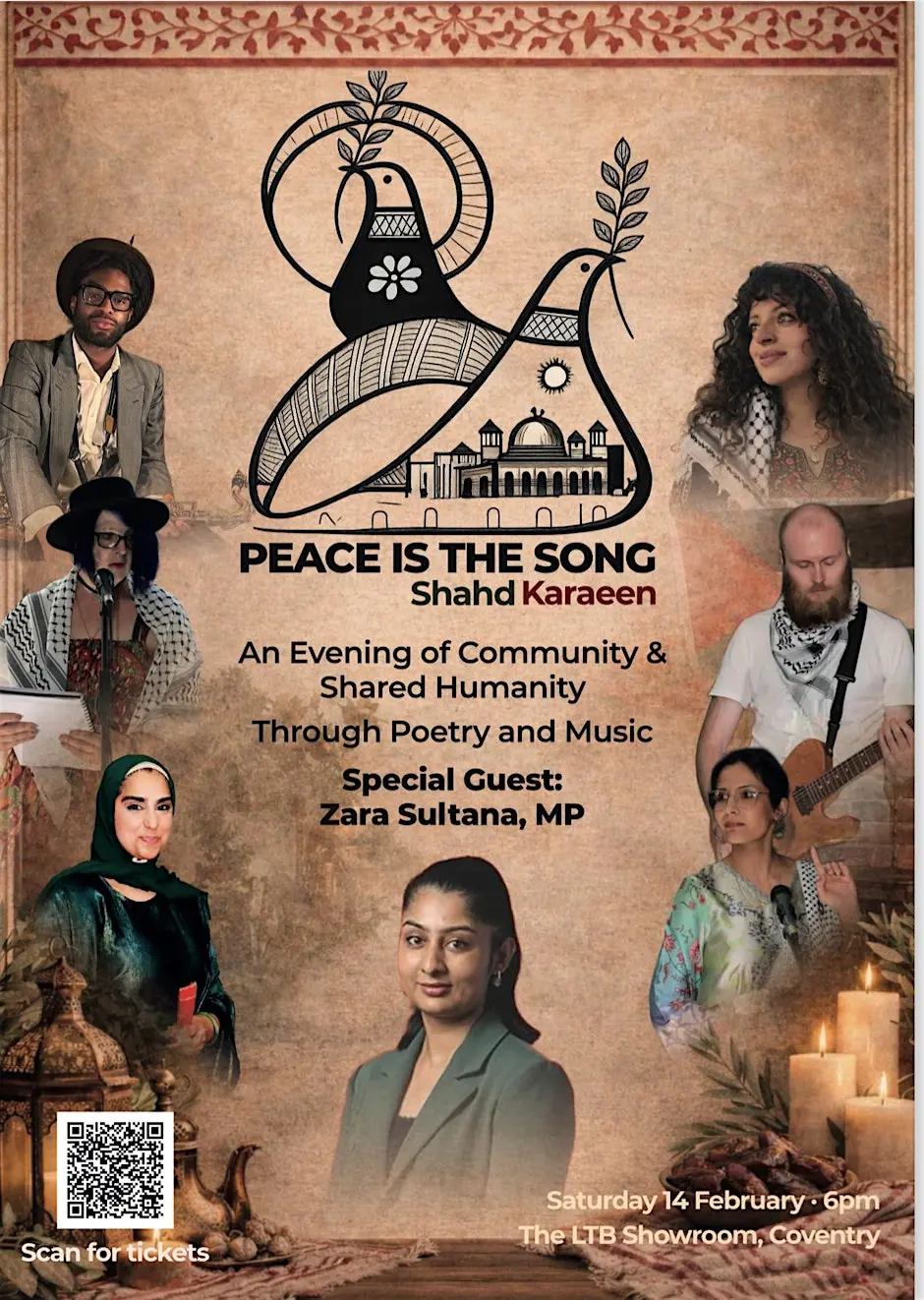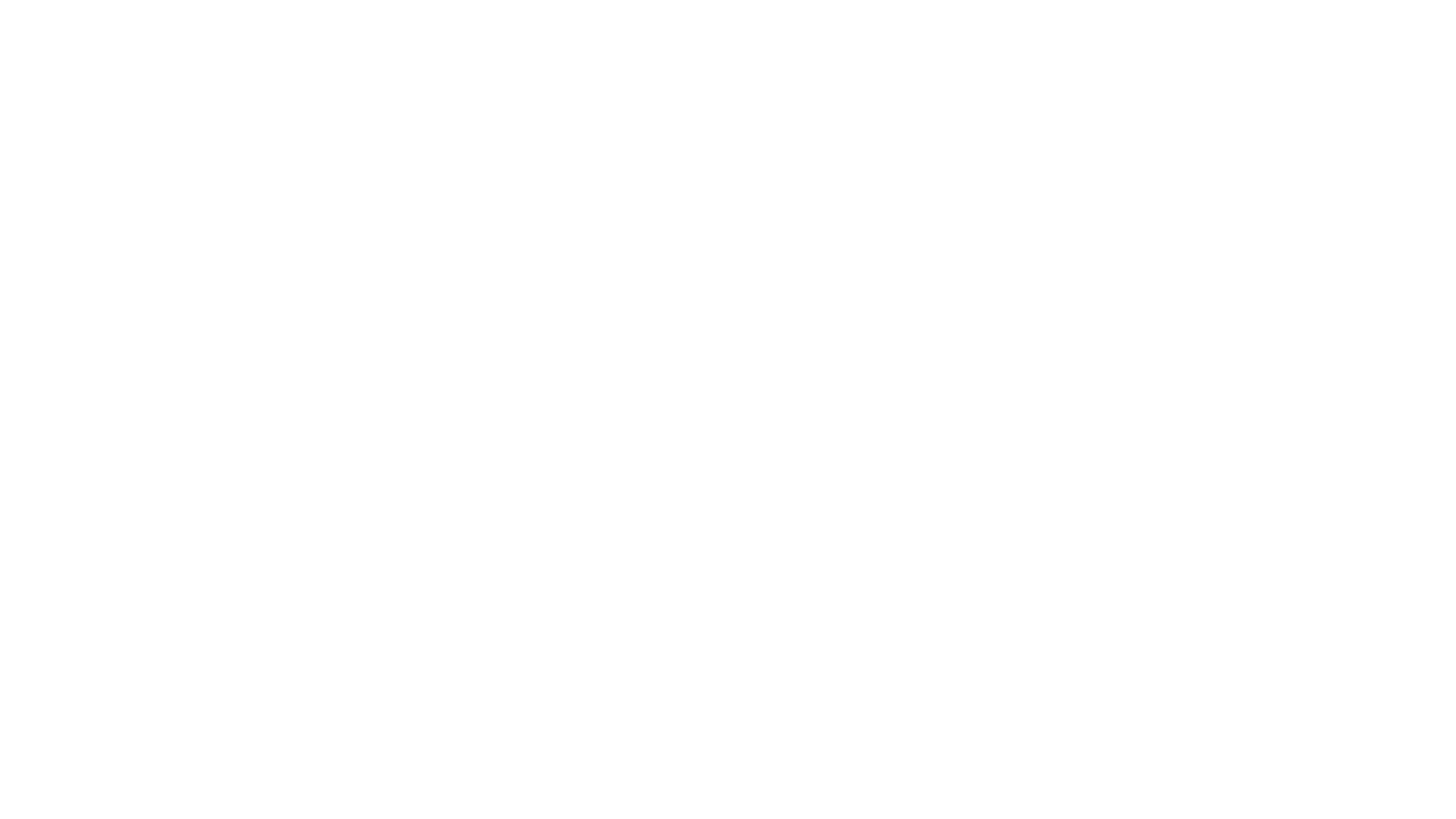حرب المصطلحات وتبييض الجريمة: كيف يُعاد تشكيل الرواية لتجريم الضحية وتبرئة الاحتلال؟

حين تتراكم الأدلة إلى درجة يستحيل معها الإنكار، لا تلجأ السلطة السياسية والإعلامية إلى نفي الوقائع، بل إلى نقل المعركة من الواقع إلى اللغة، ومن الحدث إلى تأطيره. فالكلمات ليست مجرد أدوات وصف، بل مفاتيح للشرعية والمسؤولية والمحاسبة. ومن هنا، يصبح التحكم في المصطلح شكلًا من أشكال التحكم في الوعي الجمعي، وفي نهاية المطاف في مسار العدالة نفسها.
خلال العامين الأخيرين، ومع تصاعد حجم القتل والتجويع والحصار والتدمير في غزة، برزت منظومة خطابية متكاملة تقودها حكومة نتنياهو، ويشارك فيها دونالد ترامب والإعلام اليميني الغربي، هدفها طمس الجرائم الموثقة وإعادة تعريفها ضمن قاموس أمني وأيديولوجي. هذه المنظومة لا تكتفي بتبرئة الاحتلال أو إعادة صياغة أفعاله، بل تتقدم خطوة إضافية نحو تجريم الضحية نفسها، وتحويل المطالبة بالحقوق إلى تهمة، والتضامن إلى شبهة.
وخلال الشهر الأخير تحديدًا، ازدادت شراسة هذه المنظومة الإعلامية الموجَّهة، وانتقلت من مرحلة التلاعب بالمصطلحات إلى مراحل أكثر تقدمًا من التزييف وقلب الحقائق، مقرونة بإجراءات عملية تسعى إلى إسكات أي صوت يحاول فضح جرائم الحرب أو مساءلة مرتكبيها. لم يعد الأمر مقتصرًا على خطاب إعلامي منحاز، بل اتخذ طابعًا سياسيًّا وقانونيًّا مباشرًا.
فقد شهدنا:
- منعًا أو تضييقًا متعمّدًا على دخول الفلسطينيين أو الداعمين العلنيين لحقوقهم إلى الولايات المتحدة، تحت ذرائع أمنية فضفاضة، تُستخدم لمعاقبة الموقف السياسي لا السلوك الجنائي.
- فرض عقوبات وضغوط مالية وإدارية على جامعات أمريكية شهدت أنشطة طلابية أو أكاديمية مناهضة للإبادة الجماعية، في سابقة تمسّ جوهر حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي.
- استهدافًا غير مسبوق لأدوات العدالة الدولية نفسها، عبر فرض عقوبات أو التهديد بها ضد قضاة في محكمة الجنايات الدولية، في محاولة واضحة لردع أي مسار قانوني للمحاسبة.
- ملاحقة ممثلة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، ليس بسبب خطأ مهني مثبت، بل بسبب قيامها بواجبها في توصيف الوقائع وفق القانون الدولي.
إلى جانب ذلك، جرى توسيع تعريفات “التحريض” و”التطرف” على نحو متعمّد لتشمل:
- باحثين وأكاديميين.
- صحافيين
- منظمات حقوقية.
- قضاة وخبراء قانون دولي.
ما يعني أن الهدف لم يعد مجرد الدفاع عن إسرائيل، بل تحصينها من أي مساءلة حالية أو مستقبلية، وتجريم آليات المحاسبة ذاتها.
بهذا المعنى، لم تعد حرب المصطلحات أداة تكميلية للحرب السياسية، بل أصبحت أداة مركزية لإدارة الإفلات من العقاب: إسكات الشهود، وتخويف المؤسسات، ونزع الشرعية عن القانون، وإعادة صياغة الجريمة بوصفها “رواية متنازعًا عليها” لا حقيقة موثقة.
ومن هذه النقطة تحديدًا، يصبح تحليل هذه المنظومة الخطابية والإجرائية ضرورة، لا لفهم ما يُقال فقط، بل لفهم ما يُمنع أن يُقال، ومن يُعاقَب لأنه قاله.
أولًا: هندسة اللغة كأداة سياسية
التضخيم الانتقائي للمصطلحات
شهد الخطاب السياسي والإعلامي تصاعدًا غير مسبوق في استخدام مصطلحات مثل:
- الإرهاب الإسلامي.
- التطرف الإسلامي.
- معاداة السامية.
- كراهية اليهود.
لا تُستخدم هذه المفردات هنا بوصفها توصيفات دقيقة لسلوكيات محددة، بل كمظلّات اتهامية واسعة تُلصق بأي تعاطف مع الفلسطينيين أو أي نقد لإسرائيل. وبهذا تتحول اللغة من أداة تحليل إلى أداة ضبط سياسي، ويُعاد تعريف الموقف الأخلاقي بوصفه تهديدًا أمنيًّا.
الإخفاء المقصود للمصطلحات القانونية
في المقابل، جرى إقصاء متعمّد لمصطلحات ذات تعريف قانوني واضح، مثل:
- الإبادة الجماعية.
- التجويع كسلاح.
- جرائم الحرب.
- العقاب الجماعي.
- الحصار غير القانوني.
هذا الإقصاء ليس لغويًّا بل سياسيًّا؛ لأن هذه المفردات تنقل النقاش من مستوى الرأي إلى مستوى القانون، ومن حلبة السردية إلى ساحة المساءلة. استخدامها يعني الإقرار بوجود جريمة، وهو ما تسعى هذه المنظومة الخطابية إلى تفاديه بكل الوسائل.
ثانيًا: التلاعب السببي وربط الجريمة بالاحتجاج
تحميل التضامن مسؤولية العنف
أصبح من الشائع ربط أي حادث جنائي أو أمني في الغرب بالمظاهرات المؤيدة لفلسطين، حتى في غياب أي علاقة سببية مثبتة. حوادث إطلاق النار أو الطعن تُقدَّم أحيانًا وكأنها نتيجة مباشرة لخطاب التضامن، في ممارسة تعتمد على التلازم الزائف لا على الدليل.
هذا النمط لا يسعى إلى تفسير العنف، بل إلى:
- شيطنة الاحتجاج.
- تجريم التعبير السياسي.
- إيجاد بيئة عدائية ضد أي حراك متضامن مع الفلسطينيين.
ازدواجية المعايير في توصيف العنف
في الوقت ذاته، لا يُربط العنف المنهجي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية بأي “ثقافة تحريض”، ولا تُناقَش دعوات علنية من وزراء إسرائيليين للتجويع والطرد والتدمير بوصفها خطاب كراهية أو تحريضًا على العنف. هنا يتضح أن المشكلة ليست في العنف، بل في هُوية مرتكبه.
ثالثًا: تجريم التضامن وقلب المعايير الأخلاقية
تحويل المطالبة بالحقوق إلى تهمة
بات دعم الدولة الفلسطينية، أو الدعوة لوقف إطلاق النار، أو المطالبة بإنهاء الاحتلال، يُقدَّم بوصفه:
- تحريضًا على الإرهاب.
- أو تواطؤًا أيديولوجيًّا معه.
وهذا يمثل انقلابًا كاملًا في المعايير الأخلاقية، حيث يُعاد تعريف الحق بوصفه تهديدًا، في حين يُمنح الاحتلال صفة “الدفاع المشروع”.
نزع الشرعية السياسية عن الفلسطيني
الهدف من هذا الخطاب ليس مواجهة العنف، بل تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها السياسي والحقوقي، وحصر الفلسطيني في صورة “مشكلة أمنية” لا بوصفه طرفًا صاحب حق.
رابعًا: قلب الاتهام وتبرئة الجلاد
من أكثر أوجه الخطاب الراهن فجاجة، أن الاتهامات الموجهة للفلسطينيين تنطبق بالكامل، وبشكل موثّق، على الطرف الذي يروّج لها.
حين يُتَّهَم الفلسطيني بتمجيد العنف، يُتجاهَل أن وزراء في حكومة نتنياهو دعوا علنًا إلى:
- تجويع المدنيين.
- تدمير أحياء كاملة.
- طرد السكان قسرًا.
ومع ذلك، لا تُوصَف هذه الدعوات بأنها تحريض، بل تُغلف بمصطلحات مثل “الردع” و”الأمن”.
وحين يُوصَف الفلسطيني بالإرهاب، يُغضّ الطرف عن:
- عنف استيطاني منظم ومسلّح.
- اعتداءات يومية موثقة على المدنيين.
- حماية عسكرية وقانونية كاملة للجناة.
الفرق هنا ليس في الفعل، بل في من يملك سلطة التسمية.
أما التحريض، الذي يُقدَّم كصفة لصيقة بالمجتمع الفلسطيني، فيغيب الحديث عنه بالكامل عندما يتعلق الأمر بـ:
- مناهج تعليمية إسرائيلية تنكر وجود الفلسطيني.
- شعارات علنية في مسيرات المستوطنين تدعو للإبادة.
- خطابات دينية سياسية تبرر القتل والطرد.
وبهذا يصبح مفهوم التحريض تعريفًا انتقائيًّا، يُستخدم لمعاقبة الضحية وحماية المعتدي.
خامسًا: خطاب “إصلاح الضحية” وتطبيع الجريمة
يتكرر الحديث عن “اجتثاث التطرف من عقول الفلسطينيين” و”إعادة تأهيل المجتمع الفلسطيني”، وكأن الاحتلال والحصار والقتل اليومي ليست عوامل بنيوية للعنف، بل مجرد تفاصيل ثانوية. يُحمَّل الفلسطيني مسؤولية معاناته، في حين يُعفى الاحتلال من أي مساءلة أخلاقية أو سياسية.
في المقابل، لا يُطرح أي خطاب مماثل بشأن:
- إصلاح التطرف الاستيطاني.
- تفكيك خطاب الكراهية داخل الحكومة الإسرائيلية.
- محاسبة التحريض العلني من أعلى المستويات السياسية.
وهذا الصمت ليس خللًا في التحليل، وإنما جزء من وظيفة الخطاب نفسه.
سادسًا: الوظيفة النهائية لهذا الخطاب
ما تنتجه هذه المنظومة الخطابية هو:
- تبييض ممنهج لصفحة الاحتلال.
- تعطيل المساءلة القانونية الدولية.
- تحويل الجرائم إلى “سياق أمني معقّد”.
- تجريم الضحية وتحويلها إلى متهم دائم.
وبذلك تُختزل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وحقوق إلى ملف أمني وأخلاقي تُلام فيه الضحية على وجودها وصمودها.
كيف يمكن مواجهة هذه المنظومة؟
- استعادة المصطلح القانوني: الإصرار على لغة القانون الدولي وعدم القبول بإزاحتها لمصلحة القاموس الأمني.
- تفكيك العلاقة الزائفة بين التضامن والعنف: المطالبة بالأدلة وفضح منطق الإيحاء والتعميم.
- كشف قلب الاتهام وازدواجية المعايير: عبر المقارنة المباشرة بين الخطاب الموجَّه للفلسطيني والخطاب المسكوت عنه إسرائيليًّا.
- نقل النقاش من الأخلاق المُسيّسة إلى القانون: لأن القانون أقل قابلية للتلاعب من الخطاب القيمي الفضفاض.
- رفض موقع الدفاع وفرض موقع المساءلة: عدم التعامل مع الاتهام كمسلّمة، بل قلب السؤال: من يُحاسَب ولماذا؟
ما يجري اليوم ليس خلافًا على توصيف حدث، ولا سجالًا إعلاميًّا عابرًا، بل عملية منظمة لإعادة إنتاج واقع سياسي وأخلاقي جديد، تُمحى فيه الجريمة من القاموس، وتُعاد صياغة الضحية بوصفها الخطر، ويُقدَّم الإفلات من العقاب على أنه ضرورة أمنية أو استقرار دولي.
لقد تحولت اللغة إلى سلاح مركزي في هذه المعركة:
سلاح يُستخدم لطمس الإبادة، وتبييض الحصار، وتفريغ جرائم الحرب من مضمونها القانوني، ثم إعادة تقديمها كـ“وقائع معقّدة” أو “تداعيات أمنية”. وفي المقابل، تُستخدم اللغة نفسها لتجريم الضحية، لا بسبب ما تفعله، بل بسبب وجودها، وصمودها، ورفضها القبول بدور الضحية الصامتة.
الأخطر في هذه المنظومة ليس ما تقوله فقط، بل ما تمنع قوله. فحين تُعاقَب الجامعات، ويُلاحَق القضاة، ويُستهدَف مقرّرو الأمم المتحدة، ويُضيَّق على الباحثين والصحافيين، نكون أمام انتقال واضح من مرحلة السيطرة على الرواية إلى مرحلة تجريم الحقيقة ذاتها.
لم يعد المطلوب تبرير الجريمة، بل تعطيل كل آلية يمكن أن تُسمّيها جريمة.
وفي هذا السياق، يصبح قلب الحقائق سياسة متكاملة:
- العنف الموثّق يُعاد تسميته دفاعًا.
- التحريض العلني يُغلف بالأمن.
- الجرائم الممنهجة تُختزل في “أخطاء”.
- والمطالبة بالعدالة تُصوَّر كتحريض أو كراهية.
وبهذا لا يُحاصَر الفلسطيني بالسلاح والحصار فقط، بل يُحاصَر أيضًا باللغة، وبالتوصيف، وبالمفاهيم التي تُنزع منه شرعية الألم قبل أن تُنزع منه الأرض.
إن ما نشهده اليوم هو صراع على المعنى قبل أن يكون صراعًا على الأرض.
صراع يُراد فيه أن يُعاد تعريف القانون، وأن تُفرَّغ العدالة من مضمونها، وأن تتحول المحاسبة إلى تهديد، والحق إلى تهمة، والضحية إلى مشتبه به دائم.
من هنا، لا تصبح مواجهة هذه المنظومة ترفًا فكريًّا أو نقاشًا لغويًّا، بل ضرورة سياسية وأخلاقية. فالدفاع عن المصطلح الصحيح هو دفاع عن الحقيقة، والإصرار على اللغة القانونية هو إصرار على المحاسبة، ورفض قلب الاتهام هو رفض تحويل الظلم إلى أمر طبيعي.
إن أخطر ما يمكن أن نسمح به ليس أن تُرتكب الجريمة، بل أن تُعاد صياغتها حتى لا تُرى جريمة.
وعندما يحدث ذلك، لا يكون الإفلات من العقاب نتيجة عرضية، بل هدفًا معلنًا، وتكون المعركة القادمة معركة على الذاكرة نفسها: ماذا نسمّي ما جرى؟ ومن يملك حق التسمية؟
هنا تحديدًا، تتجاوز هذه المعركة فلسطين، لتصبح اختبارًا لمصداقية القانون الدولي، وحرية التعبير، واستقلال المعرفة، ومعنى العدالة في عالم لم يعد يُنكر الجريمة، بل يسعى إلى تطبيعها عبر اللغة.
اقرأ أيضًا:
- هكذا قرأ الدكتور إبراهيم حمامي نتائج الانتخابات البريطانية
- من ممارسات المنافقين في الأوقات الحرجة
- اجتياح رفح جريمة حرب متكاملة الأركان
جميع المقالات المنشورة تعبّر عن رأي أصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المنصة
الرابط المختصر هنا ⬇